

إن فكرة الانتظار، بشكل عام، هي فكرة تجري على الإنسان، وتجعله في الأساس كائناً ثقافياً، وقد انطوت في جوهرها على الانتقال من التكيّف الوراثي مع البيئة الطبيعية إلى التكيّف الثقافي. بمعنى أن أي منتج ثقافي كفكرة الانتظار مثلاً يعدُّ تجليّاً من تجليات التفاعل الإنساني مع الظواهر الحياتية- كالظاهرة الدينية على سبيل المثال- فهل تعدُّ فكرة انتظار المخلص الموعود ظاهرة دينية أم منتجاً ثقافياً ؟ بلا أدنى شك هي منتج ثقافي لأنها تنبع من الإنسان وتتفاعل معه ولا يمكن أن تكون مفروضة عليه من الخارج، ولا يمكن أن يتم هذا التفاعل مطلقاً لأن الدين يختلف عن التدين ، الدين هو المطلق، بينما التدين هو ما ينتجه الفكر الإنساني المحكوم بسياقات بشرية يحتمل الخطأ والصواب ، لو جئنا إلى القول السائد ما يحدث في العالم من الظلم والفساد هو بحكم الله وعلينا الانتظار والصبر والدعاء ،هذا النص يحمل في طيّاته ثلاثة حجب:
أولاً: طبيعة السلطة، وهو يتعلق بطبيعة البشر وقدرته على التفاعل البيئي ضمن بنيته المخلوقة.
ثانياً: رغبة القائل به في ممارسة سلطته على من يتوجه إليهم بالخطاب، وهذه السلطة هي سلطة الهيمنة.
ثالثاً: النص يحجب ذاته بذاته.
وفي الطرف الآخر هناك حديث نبوي شريف : "أفضل العبادة انتظار الفرج". هذا النص الديني قاله خاتم الأنبياء والمرسلين (ص)، إذاً هناك مؤشرات نحو التقدم والانحدار في الفكر الديني الذي سيكون له تأثير في البنية الفكرية الدينية لدى الأفراد، لذا يجب أن يرسم الامتداد الثقافي بوصفه حركة تواصلية ترسم معالم التأثير والتأثر بين الأديان وما يستجد من ظهور مدارس فكرية خلال حركة التاريخ البشري. وثانياً: الحديث الشريف يتحرك ضمن سياقه الثقافي في ظل المتغيرات التاريخية، بمعنى أن النص لا يحتمل التأويلات التي تخرجه عن سياقه الثقافي المرسوم.
والآن، لو جئنا ونظرنا إلى البنية الدينية المرتكزة على النص الديني، لوجدناها تتجاوز أحياناً حدود النص الأصلي، لتتحول إلى منظومة من الهوامش والشروح والنصوص الموازية. فكل ما يكتب حول فكرة الانتظار إنما هو بتأثير من النص الأول الذي ينتج نصوصاً إضافية تستمد قدسيتها منه وربما حتى تفوقه. هذا ما تؤكده لنا مدارسُنا في بعض الجوانب الثقافية من بنيتنا الدينية في تفسير فكرة الانتظار التي جرت أدلجتها بهدف االضبط والتخدير والدمج، فأصبحت بالتالي فكرة الانتظار غير مستقرة دلالياً من ناحية، وضعف تطبيقها من ناحية أخرى. هذه الثغرة أغلقت باب التفاعل مع الثقافات الأخرى الخارجية في عملية التغيير من خلال الاتصال الثقافي .
من هنا بدأ مفهوم صراع الحضارات أو كما أسماه صموئيل هنتنغتون في كتابه المعنون " بصدام الحضارات" : إعادة صنع النظام العالمي بيد أن فكرة الانتظار لا تطرح مفهوم إعادة صنع النظام العالمي وذلك لأسباب عديدة :
أولاً: إن مفهوم الدولة غير متبلور أو غير مكتمل الأركان، حيث يعتبر الإيمان بمبدأ الولاية شرطاً أساسياً في انتظار المخلص الموعود عند المسلمين الشيعة.
ثانياً: عدم المثاقفة كأحد الأوجه الثقافية لناحية الأخذ والعطاء بين الحضارات البشرية المتعددة.
ثالثاً : اعتبار المثاقفة كشكلٍ من أشكال الاستعمار التي تفرز ثقافة المستعمر من خلال ما أحدثته الحملات الإمبريالية لدى كل الشعوب، حين تذوب الفوارق بين الخصوصية والكونية وما يعيشه العالم اليوم من غزو ثقافي جسدته العولمة بوصفها إحدى تجليات المثاقفة.
من المؤكد أن الانتظار بهذا الشكل أخذ بُعداً سلبياً إلى درجة تهيأت به أرضية خصبة لظهور الحركات المهدوية أضعفت مبدأ فكرة الانتظار من ناحية، وعدم مراعاة السياقات الاجتماعية والثقافية التي استندت عليها فكرة الانتظار من ناحية أخرى، خاصة حين تكون هذه الفكرة هي محو الحقائق. فالكثير من الأسماء تُعمي الحقيقة، مثلاً لو سألنا أتباع إحدى الحركات المهدوية: من هو المهدي المنتظر الذي تنتظرون عودته في نظركم ! أهو الأب الذي دخل في الغيبة الكبرى في القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي، أم الابن الذي غاب عن الأنظار هو أيضاً في القرن 21 الميلادي بعد ظهوره ؟ لذلك فإن التعبير عن الأسماء التي تلعب دوراً في التبادل الثقافي أو الانفتاح الثقافي أو التنوع الثقافي من خلال القنوات الإعلامية المختلفة وتحت مظلة فكرة الانتظار لا يبرّر البعد الأيديولوجي التي ترزح تحته هذه المفاهيم .
من هنا بدأت حركة صراع الحضارات، ونحن في هذا الجزء من البحث نركز على فكرة الانتظار كيف أوجدت الدوائر الغربية أرضية صالحة لصراع الحضارات حول المخلص الموعود لإضعاف عقيدة المهدي المنتظر عند المسلمين، وتحديداً الشيعة الاثني عشرية فقاموا بالتبشير لنموذج رأسمالي ضمن بوتقة مذهبية .
وهذا التفكير كان بداية مشروع الشرق الأوسط الكبير وصناعة القرار العالمي كما هو مشاهد في عالمنا المعاصر، وحتى الذين رفعوا شعار حوار الأديان ضمن فكرة انتظار المخلص الموعود من الشيعة أو غيرهم لم يدركوا أن الحوار يقتضي أطرافاً متساوية ، وكلما كان الطرف ضعيفاً فلن يكون حواره إلا لوكاً للمفاهيم التي لم يع بعد امتداداتها ، ولهذا لم تنجح كل المؤتمرات والندوات الداعية إلى الحوارات المهدوية لعدم التكافؤ بين المتحاورين من حيث البعد العقائدي والاجتماعي والثقافي والسياسي. وكانت النتيجة انخراط الثقافة الضعيفة حول فكرة انتظار المخلص الموعود وبشكل قهري لم ينصهر حتى مع أقرب مجتمع إسلامي له. والحمد لله ربّ العالمين


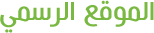
 المهدي المنتظر والتحولات العالمية - 13
المهدي المنتظر والتحولات العالمية - 13
 المهدي المنتظر والتحولات العالمية - 12
المهدي المنتظر والتحولات العالمية - 12
 المهدي المنتظر والتحولات العالمية - 11
المهدي المنتظر والتحولات العالمية - 11
 المهديالمنتظر والتحولات العالمية - 10
المهديالمنتظر والتحولات العالمية - 10
 المهدي المنتظر والتحولات العالمية - 9
المهدي المنتظر والتحولات العالمية - 9
 المهدي المنتظر والتحولات العالمية - 8
المهدي المنتظر والتحولات العالمية - 8
 المهدي المنتظر والتحولات العالمية - 7
المهدي المنتظر والتحولات العالمية - 7
 المهدي المنتظر والتحولات العالمية - 6
المهدي المنتظر والتحولات العالمية - 6
 المهدي المنتظر والتحولات العالمية - 5
المهدي المنتظر والتحولات العالمية - 5
